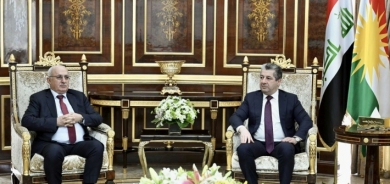الغرب الأخلاقي وعمرو بن العاص

محمد المحمود
عندما طرح أميرُ البيان/ شكيب أرسلان سؤاله الشهير: "لماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدّم غيرهم؟" (في كتاب صدر عام 1930) أثار الجدل الواسع؛ لم يكن يتساءل مُسْتَفْهِما؛ بِقَدر ما كان يتساءل مُتَعجّبا مُسْتَنكِرا. فالمسكوت عنه في هذا التساؤل: يقين قاطع باستحقاق الذات للتقدم على الآخر/ أي آخر.
اليقين المُتَضَمّن يقول: المسلمون حقهم التقدّم، حقهم أن يتقدموا؛ هذا هو الطبيعي، وهذا الطبيعي لا يحتاج لِتحليلٍ ولا لِتعليلٍ ولا لتبرير. أما أن يتقدّم غيرُهم عليهم، فهذا ليس بطبيعي، ويحتاج "اللاطبيعي" لِتحليلٍ وتعليلٍ وتبرير، تماما كما هو حال "المُبتدأ" في قواعد النحو العربي، فالمبتدأ حقَه التقديم أصالة، هذا مكانه الطبيعي، وإن تأخر عن الخبر في جملة ما؛ وَجَب البحث عن الأسباب والعلل والمُبرّرات.
أيضا، تلك المقالة المنسوبة للشيخ محمد عبده، رائد الإصلاحية الدينية الإسلامية في العصر الحديث، التي تطرح في سياق تعجّبي، ومضمونها: رأيت في الغرب إسلاما ولم أرَ مسلمين، ورأيت مسلمين في ديار الإسلام ولم أرَ إسلاما. وبعيدا عن صحة نسبته للشيخ الإمام، فإن ما يعنينا أنها أصبحت مقولة شائعة في المجال التداولي العربي والإسلامي. وهنا أيضا ثمة ما هو مسكوت عنه، إذ تقول ما لا تُصرّح به من كون الإسلام ـ والإسلام وحده! ـ هو الذي يتضمن منظومة الأخلاق الناجعة الضامنة للتطور والتقدم، وأن الغرب إن تقدموا وتطوّروا، فإنما ذلك بأخلاق الإسلام، وإن لم يقصدوها، والمسلمون إن تأخروا وتخلّفوا حقيقة، فإنما ذلك بسبب تخلّيهم عن الإسلام، أي تخليهم عن التقدم المكتوب لهم أزلا وأبدا!
كلا المقولتين: مقولة عبده ومقولة أرسلان تصدران عن "جرح نرجسي" عميق. كلا المقولتين تقول ـ ضمنا: "نحن الأولى"، "نحن الأحق"، "نحن المتقدمون حقيقة؛ وإن بدا ـ بشكل مخجل ومؤلم وفاجع ـ أننا متخلفون جدا جدا جدا"، "نحن المتقدمون قدرا، ولكن ثمة مَن عَبَث بالأقدار".. إلخ، تأوّهات المُعَذبين بحقيقتهم/ حقيقة واقعهم الأليم.
وكلا المقولتين ـ أيضا ـ تطرح ما تطرحه في ما يُشبه "رقصة ألم" مشوبة بهلوسات و....؛ لتتجنّب الحقائق المؤلمة: حقيقة أن الغرب أبدع ما لم يستطيعوا إبداعه، وللقفز على حقيقة أن الغرب تفوّق عليهم بذكاء واجتهاد ومواصفات أخلاقية عريقة تضرب في أعماق تاريخه. وباختصار، لتتجنّب حقيقة أن الغرب ـ من حيث هو تشكّل ثقافي، مُتَمايِز ومُسْتمر في التاريخ ـ هو الأحق أصالة بالتقدم، وأنهم ـ بمسار تاريخهم، خاصة تاريخهم المتأخر ـ أحق بالتخلف والانحطاط، بل وأن تقدّم وتطوّر أمثالهم ـ في مثلِ حالهم ـ يكاد يكون في حكم المستحيل.
مِن خلال تَزَاوج المَقولتين ـ وبصورة واعية أو غير واعية ـ، ومن خلال استمرار وقائع الانحطاط في تتابع يَشي بحتمية لا مفرّ منها (لا نقول بالحتمية هنا، وإنما هو توصيف لما انطبع على صفحات الوعي/ اللاّوعي العام)، خرجت المقولة الدفاعية الأخرى: نحن المُتقدّمون رُوحا وأخلاقا، والغرب متقدم ماديا. وطبعا، يدرك أي أحد أن هذه مجرد حِيلة دفاعية ساذجة، حِيلة تحاول مُداواة الجرح النرجسي النازف، إذ هي تقرّر ـ بناء على هذه المُقدّمة المدعاة ـ أننا المتقدمون حقيقة؛ لأن التقدم المادي، الذي هو من نصيب الغرب، يبقى مجرد تقدّم تافه وسطحي وزائل وغير جدير بالتقدير، بينما التقدم الروحي/ الأخلاقي، الذي هو من نصيبنا وفق هذا الادعاء، كفيل بجعلنا في مركز الصدارة عالميا، بل وأن نمارس دورنا في قيادة العالم (أستاذية العالم؛ كما هي المقولة القطبية الشهيرة)!
إذن، انشرت ـ كحيلة دفاعية ـ مقولة أن الغرب بلا أخلاق، وأننا أمَة الأخلاق، على مستوى انتشار واتساع السذاجة الجماهيرية المتأثرة بالتيارات الضدية: العروبية والإسلاموية على نحو خاص. فهل صحيح أن الغرب بلا أخلاق، وهل صحيح ـ بالمقابل ـ أننا، كعرب وكمسلمين، نحن المُتَوفِّرون على النصيب الأوفر من الأخلاق؟
للأسف، فإن تصوراتنا عن الأخلاق مغلوطة، وقد تحوّرت ـ عن قصد وعن غير قصد ـ لتتحدّد في مسائل هامشية، أو في مسائل لا علاقة لها بالأخلاق أصالة. لقد جرى التحوير لتتحدد الأخلاق في "مسائل الجنس" وفق التصور العربي/ الإسلامي.
هل كان هذا نتيجة كبت جنسي أورث كثيرا من العُقد التي تضخّمت لتلتهم بضغط الحرمان بقيّة التصورات الأخلاقية؟ أم هو نتيجة تركيز متعمّد على ما يمكن الرهان عليه في السجال مع الآخر، أي في الموضع الذي يُمكن تسجيل بعض النقاط فيه؟ البحث في هذا يطول، ولكن من الظاهر أن وضع الأخلاق التعاملية (غير الجنسية) في منزلة ثانوية، وترفيع الأخلاقية الجنسية، له جذوره التاريخية، حيث كان المرتشون، وسُرّاق المال العام، والمخادعون...إلخ، لا يتوارون خجلا من أفعالهم؛ في الوقت الذي كانوا فيه يموتون خجلا عندما يتعلق الأمر بمسلك أخلاقي ذي طابع جنسي.
المبحث الأخلاقي يؤكد أن ليست "الأخلاق الجنسية" إلا محددا خاصا ومحدودا في مجمل منظومة الأخلاق. بل هي أصلا لا علاقة لها بالأخلاق؛ إلا ـ فقط ـ من حيث انعكاساتها ـ في ظرف اجتماعي ما ـ على شبكة الأخلاق التعاملية ذات الطابع العمومي، أي شبكة الأخلاق التي تضمن للمجتمع سلامة التضامن/ السلام، كما تضمن له سلامة مسار التطور والنماء.
ما يُسمّى بالأخلاق في المجتمعات التقليدية، ليست أخلاقا بحق؛ لأنها إما مجرد شعارات مُفرّغة من مضامينها، وإما مُوَاضعات مفروضة على الأفراد بالقوة، ولا تظهر في مجال التفاعلات الطوعية. وكما يرى أشرف منصور، فإن المجتمع الحديث يتميز بالتساند العضوي، بينما التساند في المجتمع التقليدي مفروض على الأفراد من أعلى، مُمَثلا في السلطة الأخلاقية للمجتمع، وهو تساند مصطنع يعتمد على الإرغام المعنوي، وجعل الفرد متماهيا ومتطابقا مع الوعي الجمعي (الليبرالية الجديدة، ص218).
وقد لاحظ الباحث المغربي/ إدريس هاني كارثية "الادعاء الأخلاقي" لدى العرب/ المسلمين، في سياق الموقف الضدي من الغرب، فقال: "لا يمكننا التمادي في التجريح الأخلاقي للغرب بهذه الكيفية الموسومة بالعمومية والإطلاق، ضد اجتماع أصبحت الأخلاق فيه محايثة لا مفارقة. فيما أخلاقنا لا تزال أحكاما في الرؤوس وثرثرة على أطراف الألسن"؛ ليخلص بعد ذلك إلى حقيقة أن "الحداثة على حد كبير من أخلاق الضمير وأخلاقيات الإنتاج والعمل وعلى الصدق والإخلاص في العمل والنزاهة. بل إن قوة المشروع الحداثي وعنصر استمراره يكمن في أخلاقياته". (الإسلام الحداثة، ص110/111و ص 230).
إذن، وبالنظر إلى مفهوم الأخلاق كنسق كلي عام: كقوانين تواصلية ـ تفاعلية، لا نجد فقط أن الغرب أخلاقي، وإنما ـ وهذا ما هو صادم للذات ـ أن الغرب اليوم هو العالم الأخلاقي، فيما الشرق (وعالم: العرب والمسلمين، متضمن فيه بدرجة أولى) عالم يفتقر إلى الحد الأدنى من الأخلاق، أي الحد الأدنى الذي يجعله قادرا على تدبير اجتماعه الإنساني، ومن ثم نمو/ تطور هذا الاجتماع نموا/ تطورا مطردا لتحقيق "الخير العام".
لكن، هل هذا "الغرب الأخلاقي" الذي صنع ـ بفضل هذه الصفة: الأخلاقية ـ حضارته الاستثنائية، هو غرب أخلاقي منذ كان، أو ـ على الأقل ـ منذ تاريخ طويل ؟ هل أخلاقيته الحضارية (صانعة الحضارة النوعية الاستثنائية) ذات عراقة؟ أم هي ـ كما رَدّد السذج من وعاظ القومية والإسلامية ـ أخلاقية مستلهمة من تراث المسلمين، وأن لا فضل للغرب إلا في تطبيقها على الوجه الأقرب للكمال؛ فيما عجز المسلمون عن بعض هذا الكمال؟!
الجواب يأتي من عمق أربعة عشر قرنا. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه حديث المستورد بن شدَّاد الفهريِّ أنه ـ أي المستورد ـ قال عند عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " تقوم الساعة والروم أكثرُ الناس"، فقال له عمرو: أبصِر ما تقول، قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لئن قلت ذلك، إن فيهم لَخصالًا أربعًا: إنهم لأَحلمُ الناس عند فتنةٍ، وأسرعُهم إفاقةً بعد مصيبة، وأوشكُهم كرَّة بعد فرَّة، وخيرُهم لمسكين ويتيم وضعيفٍ، وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم مِن ظلم الملوك.
هنا، لن نناقش مسألة الغيبيات (قيام الساعة في ظرف ما)، ولا صحّة نسبة هذا التحديد/ النبوءة إلى النبي، فهذه مسألة إيمانية من أولها إلى آخرها، كما أن صحة النسبة مسألة قناعة بشروط النقل، ما سنناقشه هنا هو التوصيف الأخلاقي للروم/ الغرب على لسان عمرو بن العاص.
تنبع أهمية هذا التوصيف في كونه صادرا عن رجل مشهور بالدهاء/ الذكاء (أحد أشهر دهاة العرب وفق التصنيف التراثي)، ليس هذا فحسب، بل ومن ذوي التجارب، فقد كان سفيرا وتاجرا مترحلا قبل الإسلام، وبعد الإسلام أحد قواد القوات الغازية لبلاد الشام، ثم هو قائد الغزو العربي الإسلامي لمصر. أي أن الرجل يتوفر على خبرة عملية واسعة المجال بأحوال العالم القديم شعوبا وحضارات.
يبدأ النص بأن راوي الحديث/ المستورد يذكر نصا تنبؤيًّا يؤكد أن ثمة مستقبلا عظيما للروم، حيث سيصبحون في مستقبل الأيام أكثر الناس. ومن معاني الكثرة في لغة العرب: القوة. عمرو بن العاص رأي في هذه النبوءة تعارضا مع واقع يُشاهده بعينه، أي مع واقع أن العرب هزموا الروم في الشام وفي مصر (والتصور العربي آنذاك لحجم الإمبراطورية الرومانية كان متواضعا)، أي أن قوة/ كثرة الروم في انحسار واضح ومتتابع، وحيث تصورهم لنهاية العالم كان محدودا (كانت عند بعضهم في غضون عدة أجيال)، فقد ظن عمرو أن الراوي وَاهِم فيما ينقله عن النبي الأعظم، ولهذا طلب منه التأكد بقوله: "أبصِر ما تقول"، أي تأكد من صحة نقلك للخبر. لكن، عندما أكّد له الراوي ذلك، أصبحت استعادة الروم ـ مستقبلا ـ لقوتهم أمرا مُتَحقّقا عند عمرو، وحينئذٍ ـ وكخبير استراتيجي بشؤون العالم القديم ـ حاول البحث عن أسباب هذا الاستئناف الرومي/ الغربي للقوة.
هنا، نصل إلى ما يهمنا، وهو أن عمرو عندما بحث عن الأسباب لم يجدها في شيء؛ كما وجدها في "القوة الأخلاقية" التي تُشكّل ـ في تصوّره ـ هوية الروم/ الغرب. لم يبحث عمرو في مقومات القوة المادية للروم، لم يحاول أن يتتبع الأحداث الظرفية ليستشفّ منها ما عساه أن يكون سببا في هذه الاستمرارية التي يبدو وكأنها خاصة بهم؛ دون سائر الأمم، بل وجدها ـ وعن سابق معرفة بهم؛ تمتدّ لما قبل الإسلام ـ في الأخلاق.
الغريب أن الصفات الأربع/ الخمس التي ذكرها عمرو قبل أربعة عشر قرنا هي أهم عناصر القيم الأخلاقية المُؤسِّسة لحضارة الغرب اليوم: روم الأمس. وهي:
1ـ "َأحلمُ الناس عند فتنةٍ"، والمقصود أنهم يتثبّتون عند تشابه وتشابك الأحداث، ولا يسارعون إلى الصراعات البينية، وباختصار: الحرص على الاستقرار.
2ـ "وأسرعُهم إفاقةً بعد مصيبة"، بمعنى أن المصائب/ الكوارث/ الهزائم لا تكسرهم، بل يعودون ـ وبقدرة على التحمّل، وبنفس طويل يرى آماد المستقبل في تجاوز اللحظة ـ لاستئناف الحياة/ البناء. والحالة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية نموذج.
3ـ "أوشكُهم كرَّة بعد فرَّة"، أي أنهم لا يعدّون الفشل نهاية المطاف، لا يعدّون الهزيمة واقعة نهائية، بل هم قادرون على مراجعة أنفسهم، ونقد سلوكياتهم، والبداية من جديد. ومن كانت هذه حاله، فهو لا ينهزم أبدا في الحرب؛ مهما توالت هزائمه في المعارك.
4ـ "وخيرُهم لمسكين ويتيم وضعيفٍ"، والمراد هنا "الحس الإنساني"، الاهتمام بالإنسان من حيث هو إنسان، وخاصة عندما يكون ضعيفا. وهذا ما نراه في سلوكيات "التبرّع" بالثروات للخير العام، كما نراه في نظريات العدالة الاجتماعية وتتابعه بدافع إنساني.
5ـ "وأمنعهم مِن ظلم الملوك"، والمقصود النفس الديمقراطي المضاد للاستبداد، فمنذ اليونان قديما، وخلال أكثر فترات الإمبراطورية الرومانية، والمجالس البرلمانية والاستشارية والنقابية...إلخ كانت حاضرة، بينما العرب/ المسلمون أقاموا أكبر الإمبراطوريات التي امتد بعضها لمئات السنين، ومع هذا لم يؤسسوا أي نموذج لأي تجربة برلمانية أو شبه برلمانية، ولو لمرة واحدة طوال تاريخهم، وعلى اختلاف العناصر/ الأعراق المكونة لتلك الإمبراطوريات التي كانت ذات طابع شرقي. وأما حدث في التاريخ العربي/ الإسلامي الحديث من محاولات وتجارب، فإنما هو بدافع استلهام للتجارب الغربية في سياق التحضّر العام.
باسنيوز