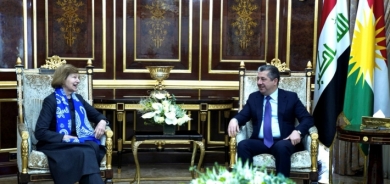العنف وفريضة اللّاعنف

باحث ومفكر عربي
ـــــــــــــــــــــــــ
* مفكر وباحث عربي من العراق، له عدد من الكتب في قضايا الفكر والقانون والسياسة والأديان والأدب والثقافة والنقد. أستاذ القانون الدولي وحالياً نائب رئيس جامعة اللّاعنف وحقوق الإنسان في جامعة أونور(بيروت) .
" لقد درست نظرية اللّاعنف، ولست بعيداً عن الخلوص
إلى أنها تمثّل حقيقة، حَرِيّة أن يبشّر بها بالمثال،
لكنها تستلزم عظمة لا أتّصف بها"
ألبير كامو
بوحٌ متأخر
لم أكن قد اخترتُ اللّاعنف تماماً كفلسفة وطريق للوصول إلى الحقيقة والعدالة، لكن ما أعرفه أنني كنت شديد النفور من العنف، بل أزدري مع نفسي في الكثير من الأحيان من يستخدمه أو يلجأ إليه، أو على أقل تقدير لا أشعر إزاءه بالاحترام، وإنْ بقي المفهوم مشوّشاً في ذهني وملتبساً إلى حدود غير قليلة،لاسيّما ثمة أهواء عديدة كانت تتنازعني ويشدّني بعضها إلى درجة الانجذاب، خصوصاً حين يتمّ تبرير اللجوء إلى العنف دفاعاً عن الحقوق والحريات والمستقبل المنشود، لاسيّما في مواجهة العنف بالعنف.
أستطيع القول وبكل ثقة أنني كنتُ متأكداً من أنني ضد القتل، ولم أكن أستسيغ مثل هذا الفعل " الشنيع" من أي كان وتحت أية مبرّرات، لأنني كنتُ أعتقد أن ليس ثمة شيء في الدنيا يوازي قتل الإنسان أو محقه، وقد وقّعت منذ ثلاث عقود ونيّف من الزمان على مذكرة ضد "عقوبة الإعدام"، مثلما كنت ضد إرغام الإنسان على نزع معتقده أو التخلّي عن أفكاره باستخدام العنف ضدّه، حيث كانت شائعة في حينها فكرة "البراءة" أو نبذ العقيدة، وسيلة لإخراج السياسيين من دائرة السياسة، والمقصود بذلك حجب حق ممارسة السياسة عن المعارضين، والاكتفاء باحتكارها من جانب الموالاة .
بين القاتل والمقتول
كنتُ لا أزال فتىً أواجه العنف بشكل مباشر لأول مرّة، حين حدث خصام، تطوّر إلى عراك، فعنف بين صديقين لي، وإنْ لم يكونا من الأصدقاء المقرّبين، لكنّني كنت على علاقة طيبة بكليهما، فقام أحدهما واسمه عامر من آل العامري وشيخ عشيرتهم " مهدي العبد" بقتل أكرم أبو كَلل وشيخ عشيرتهم "عطية أبو كَلل" ثم انتقلت منه الزعامة إلى ولده الشيخ "كردي أبو كَلل".
القاتلُ والمقتولُ كانا قريبين منّي. والغريب إن تلك الحادثة لم تمرّ مرور الكرام، بفعل وقوع المحذور في لحظة طفولية أدت إلى القتل، حين كان كلٌ من المتخاصمين يمكن أن يلتجئ إلى استخدام السلاح، كما هو شائع بفعل عداوات ومنافسات وعنعنات، بعضها يعود إلى الماضي، لكن تداعيات تلك الحادثة وتفرّعاتها وتشابكاتها كانت كثيرة ومتشعّبة ومختلفة، وخصوصاً تركتها الاجتماعية.
القاتل كان أقرب إلى معسكر اليسار والحركة الشيوعية، والمقتول كان أقرب إلى المعسكر القومي، وهكذا اتّخذت بعض ردود الفعل ذات الطابع الصبياني، بُعداً سياسياً، إضافة إلى بُعدها العشائري، بالانحياز المسبق لهذا الطرف أو ذاك، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر.
وبعد فترة وبفعل ردود الأفعال، قَتَلَ أحمد هندي أبو كَلل شقيق المقتول، شيخ آلبو عامر "مهدي العبد"، وكان هذا من "أنصار السلام" حينها، ثم قام بعض مسلحي ألبو عامر في وقت لاحق، بقتل أحد أنسباء ألبو كَلل وهو كليدار حضرة الإمام علي، السيد حسن الرفيعي، وتبريرهم إن أحمد هندي أبو كَلل حين قتل مهدي العبد، ثأراً لأخيه كان يختبئ في منزله، وقام بإطلاق النار عليه ليرديه قتيلاً خلال مروره من أمام منزل الرفيعي.
لقد عشتُ تلك الأحداث بتفاصيلها، وكنتُ أشعر بالعطف على الطرفين (أكرم وعامر): المقتول والقاتل، فضلاً عن إن أحمد هندي أبو كَلل كان صديقاً لعمّي شوقي، مثلما كان المقتول مهدي العبد صديقاً لعمي ضياء. ولعلّ هذا الشعور لم يفارقني لفترة طويلة، إذْ كيف أستطيع التمييز بين طرفين كلاهما ضحية. ربما تعود حيرتي لأنني ضد مبدأ القتل أصلاً، وأعتبر القاتل مثل المقتول ضحية العادات والتقاليد الاجتماعية ، التي تجعل من ممارسة العنف لدرجة القتل، نوعاً من أنواع الشجاعة والرجولة والكرامة التي تستحق التمجيد والثناء والاعتزاز، ولأن المقتول مثل القاتل كان يمكن أن يلتجئ إلى القتل لولا أن القاتل سبقه بضربة بسكين حادّة أخرجت أمعاءه ليخرّ صريعاً على الأرض وسط ذهول المارّة.
وقد عاشت تلك الحادثة معي طويلاً بكل تناقضاتها، وكان عطفي مثل سخطي ينصبُّ على الطرفين اللذين كانا ضحية العنف، فمن يمارس العنف ضد الآخر، إنما يقوم بنزع إنسانيته هو بالذات، لا إفناء الآخر فحسب، وتلك محنة مزدوجة، سواء من يقع عليه العنف، أو يوقع العنف على غيره. وكنتُ أذهب أبعد من ذلك لأضع أسباب أخرى لما يحصل على الجهل والتخلّف والأميّة والعادات والتقاليد الاجتماعية البالية، بل أجد في نظام الاستغلال سبباً جوهرياً في استمرار مثل تلك الظواهر، ولم يكن الأمر يتم بعمق مطلوب، بل كان يجري ضمن شعارات عامة ومقولات مكرّرة.
وأستطيع القول إن الوضع السائد آنذاك والمستوى الثقافي والفكري لم يجعلني أتحوّل تماماً إلى اللّاعنف، على الرغم من أن بذوره كامنة، لكنه لم يشكّل قطيعة نهائية بالنسبة لي مع العنف، بحكم وجود مبرّرات أخرى لاستخداماته لأغراض آيديولوجية وسياسية، وذلك تحت ذرائع ومسوّغات مختلفة.
العنف المجنون
بعد ثورة 14 تموز (يوليو) العام 1958 انخرطت مثل العديد من أبناء جيلي في وقت مبكّر في العمل السياسي والمهني، وذلك حتى قبل اكتمال وعيي وقبل أن تدركني مهنة الحرف التي اكتسبت بُعداً أكاديمياً فيما بعد. وكان الانتماء العاطفي تحت عناوين ثورية ويسارية، هو السمة السائدة حينذاك، في البحث عن الحقيقة والطريق نحو العدالة، لاسيّما وإن الحرّية كانت شحيحة، والمساواة مفقودة والعدالة ضائعة والمشاركة غائبة. ومثل تلك الانتماءات كانت جميعها تقريباً تمجّد العنف وتعتبره وسيلة لا غنى عنها لتحقيق أهدافها، بل إن العنف حسب التعبير الماركسي كان "قاطرة التاريخ" لتحقيق التغيير المنشود، وحسب وصف ماركس فـ " الحروب كالنار تُجلي صدأ التاريخ".
وقبل ذلك صادف أن حدث العدوان الثلاثي على الشقيقة مصر في العام 1956 حين انتفض العراق من أقصاه إلى أقصاه، وسقط العديد من الشهداء بينهم ثلاثة من أبناء مدينتي "النجف" العزيزة أو "خدّ العذراء" كما تكنّى، وكانت موجة العنف الجديدة في العراق، قد ترافقت مع قيام "حلف بغداد" وتشريع عدد من القوانين ذات العقوبات الغليظة بزعم مكافحة "الأفكار الهدّامة"،وذلك بعد عقد من الزمان طغى فيه العنف، ابتدأ بإعدام 4 من الضباط المشاركين في حركة رشيد عالي الكيلاني وهم صلاح الدين الصباغ وفهمي سعيد وكامل شبيب ومحمود سلمان والسياسي يونس السبعاوي، والتي تم الإجهاز عليها بإعادة احتلال بريطانيا للعراق وشن الحرب عليه العام 1941، وإعدام قيادة الحزب الشيوعي المتمثّلة بحسين محمد الشبيبي ومحمد زكي بسيم ويهوّدا صديق، وعلى رأسها يوسف سلمان يوسف "فهد" (أمين عام الحزب) العام 1949.
دولاب العنف
حين حدثت ثورة 14 تموز (يوليو) العام 1958، كان قد بدأ العنف معها منذ اليوم الأول حيث دار دولابه بصورة متسارعة، مبتدئاً بقتل العائلة المالكة، وقد حدث الأمر بنوع من التشفّي والانتقام والقسوة، حيث تم تعليق جثة الوصي على العرش الأمير عبدالإله، على شرفات أحد فنادق الكرخ وظلّت مدلّاة هناك، والناس ترشقها بالبيض والطماطم والأحذية، وقد رويت في حوار لي مع الإعلامي توفيق التميمي والمنشور في كتاب صدر عنّي بعنوان "المثقف في وعيه الشقي - الصوت والصدى"، كم كان المنظر بشعاً وسادياً ولا إنسانياً، وكم ترك تأثيراً سلبياً عليّ إزاء ظاهرة العنف وامتهان كرامة الإنسان والتمثيل به، لاسيّما مناظر السحل الهمجية وانفلات الغرائز وانفتاح الشهية للدم والقتل بشراهة ووحشية لم يعرف العراق مثيلاً لها من قبل.
وحين قُتل نوري السعيد أقوى رؤوساء الوزارات في العراق وأكثرهم دهاءً، وتم سحله في الشوارع، تلاقف الجمهور بفرح غامر وتلذّذ مقزّز أجزاء من جسده، لتنتقل من محلّة إلى أخرى في بغداد. وحتى المحاكمات التي حصلت فيما بعد لم تستوفِ شروط "المحاكمة العادلة" كما نعرفها بعد دراستنا لها، ناهيك عن قتل وتبشيع بالضحايا حصل خارج القضاء في الموصل وكركوك العام 1959، وذلك في إطار موجة منفلتة من العنف شملت الشارع العراقي، لاسيّما حين هيمن اليسار على المشهد السياسي، وحاول إقصاء الآخرين أو تهميشهم.
لكن اليسار هو الآخر تعرّض للتنكيل بعد حين، بل إنه عانى من ضربات قاسية بعد انقلاب 8 شباط (فبراير) 1963، حيث اتّسعت دائرة العنف، لاسيّما المنفلت من عقاله، والذي تجلّى بإصدار بيان رقم 13 ممّا يسمّى " مجلس قيادة الثورة" القاضي بإبادة الشيوعيين، حيث مورس القتل بدم بارد من خلال هيئات غير نظامية عُرفت باسم "الحرس القومي" وراح ضحيته المئات من قياداته وكوادره والآلاف من أعضائه وأنصاره.
وشملت الحملة لاحقاً شنّ هجوم ضد كردستان والشعب الكردي أطلق عليه وزير الدفاع صالح مهدي عماش حينها بأنه "نزهة" ستنتهي بالقضاء على الحركة الكردية، ولكن الحكم الجديد سقط وهو مثقل بارتكاباته وعلى يد بعض أقطابه، لتبدأ مرحلة جديدة اتّسمت بعنف مقنّن، بعد أن انفلت العنف على مصراعيه.
عنف مضاد
وكان أن بدأ عنف المعارضة، حيث اتّخذ فريق يساري انفصل عن الحزب الشيوعي عُرف باسم "القيادة المركزية" بقيادة عزيز الحاج قراراً بممارسة عنف مفتوح ضد عنف السلطة الحاكمة، التي انقضّت عليه لتقتل شباباً بعمر الزهور بينهم أزهر صالح الجعفري أحد أصدقائي المقرّبين وكذلك سامر مهدي، وقد حصل الأمر في ظرف غامض وملتبس العام 1968، وكان قد سبق ذلك مقتل خالد أحمد زكي، الثوري الحالم المتأثر بجيفارا والذي قَدِمَ من لندن حيث كان يدرس، ليذهب إلى الريف وأهوار الجنوب، ليقود كفاحاً مسلحاً، كان هو أول ضحاياه.
وحين حصل الانقسام داخل الحركة الشيوعية (17/أيلول/سبتمبر/1967) كادت علاقتي بها أن تتصدّع، بسبب الخلافات التي اتّخذت طابعاً عنفياً، وإنْ كنت أميلُ إلى المجموعة الأكثر عقلانية والأقل عنفاً، لكنها هذه هي الأخرى لم تسلم من ممارسة العنف خارج القضاء. وكانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير كما يُقال، هي مقتل الشاب سامي مهدي الهاشمي العام 1968 الطالب في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية(وكنت قد تخرّجتُ من الكلية ذاتها في وقت سابق)، والذي كان محسوباً على فريق القيادة المركزية على يد ثلّة متهوّرة، وتركت تلك الحادثة غصّة في نفسي.
وكنتُ قد أدنتُ الأمر علناً ومن أي أتى، بل إنني كنت الوحيد الذي شارك في تشييع المغدور وحضرتُ لثلاثة أيام مجلس الفاتحة في جامع براثا في العطيفية، ووقفت صفاً إلى صف إلى جانب شقيقه سعدون الهاشمي وهو ما وفّر حصانة لي في حين اضطرّ الآخرون إلى التواري عن الأنظار، حيث راجت الاتهامات ضد تنظيم اللجنة المركزية، الذي كنت أنتمي إليه، وكانت جماعة القيادة المركزية قد قرّرت الانتقام منها، كما إن حضوري مجلس الفاتحة وعلاقتي بشقيق المغدور وفّر لي حصانة أخرى من جانب الحكومة ذاتها، التي كانت تتفرّج على ما يحصل، خصوصاً وإن موقفي شديد الوضوح بإدانة العنف ومطالبتي بالكشف عن المرتكب ليتخذ القضاء مجراه من جانب الحكومة التي لم تحرّك ساكناً، ومن جانبنا طرده من صفوفنا على أقل تقدير، وكان ذلك سبباً إضافياً في تصدّع العلاقة بالحزب، خصوصاً حين طالبتُ بمحاسبة المسؤولين.
وفي حوار لي مع القيادي البعثي زهير يحيى (عضو قيادة قطرية احتياط- وسابقاً عضو فرع بغداد) وكان من أصدقائي المقرّبين، وكنّا قد هوجمنا في ساحة السباع حين كنّا ننظّم احتفالاً لمناسبة الذكرى الـ 51 لثورة أكتوبر (نوفمبر/ تشرين الثاني) 1968، وقتل ثلاثة منّا وجرح 12 شخصاً، وقبل ذلك كان الهجوم على عمال الزيوت في بغداد، قلتُ له إذا بدأتم بالعنف، فالأمر ستكون نهايته وخيمة، ولن ينتهي العنف إلّا بالعنف والعنف المضاد، وذلك سيعني ضياع التجربة التاريخية والدرس الذي يمكن أن نتعلّمه جميعاً، وأقصد إنهاء العنف والجلوس إلى طاولات الحوار، وهو ما كنتُ قد اُعتمدت للقيام به في قطاع الطلبة وفي الوقت نفسه في قطاع حقوقي، ولاسيّما في التحالف الذي انبثق في إطار جمعية العلوم السياسية التي التحقت بجمعية الحقوقيين لاحقاً، حيث كنت ممثلاً للحزب في القطاعين.
وبالمناسبة تعود علاقتي بسعدون الهاشمي شقيق المغدور إلى هروبه من سجن الحلّة في خريف العام 1967 حين تم حفر نفق ليخرج عشرات من السجناء إلى فضاء الحرية. وكنت قد ساهمت في إنقاذه، حين نظّمنا سفرة طلّابية، إلى سدّة الهنديّة وفي طريق العودة قمنا بنقله إلى بغداد، لأضعه جنبي ومعه شقيقه سامي وسليم الربيعي، بسيارتي بعد وصولنا إلى علاوي الحلّة، وأقوم بنقله إلى منطقة الزوّية ببغداد، واستمرت علاقتي الوثيقة بالهاشمي في الشام حيث أصبح عضواً في قيادة الجبهة الشعبية - القيادة العامة . وقد رويت في أكثر من مناسبة حكاية هروب السجناء من سجن الحلّة، تلك التي أبدع فيها حسين سلطان " أبو علي".
دعوات لا عنفية
وبسبب موجة العنف وما أنتجته لم يكن الميل شديداً لدى القوى السياسية، لاسيّما في الممانعة إلى استخدامه،خصوصاً بتبدّل الأوضاع، وبعد فشل الحلول العسكرية للمسألة الكردية، طُرحت بعض المقترحات والأطروحات التي تدعو إلى المفاوضات والحوار وقد لعب الشخصية الوطنية الكبيرة عزيز شريف دوراً في تليين قناعات الحكومة والحركة الكردية المسلحة، باتجاه حل سلمي يرضي الطرفين ويضع البلاد على طريق التنمية وكان رسولاً أميناً بين الرئيس أحمد حسن البكر والزعيم الكردي مصطفى البارزاني، حتّى تم التوصّل إلى توقيع بيان 11 آذار (مارس) العام 1970 لحلّ المشكلة الكردية باتجاه الحكم الذاتي، الذي مثّل خطوة إيجابية، بل هامة ومتقدّمة آنذاك .
لكن تدهور الأوضاع وضعف الثقة بين الطرفين وضع حيثيات هذا الحل على المحك واندلع القتال مجدّداً في العام 1974، واضطرّت قيادة الحركة اللجوء إلى إيران وذلك بعد توقيع اتفاقية 6 آذار (مارس) 1975. وكانت نتائج تلك المعارك وخيمة، حيث سقط فيها نحو 60 ألف ضحيّة وتم تدمير منشآت ومرافق حيوية وخسارة ملايين الدولارات ، ناهيك عن التداخلات الخارجية التي لعبت دوراً مؤثراً في التشدّد من جانب الحركة وهو ما انتقده لاحقاً الزعيم الكردي الملّا مصطفى البارزاني.
ومن جهة أخرى كانت السلطة تزداد تشدّداً وتضييقاً على الحركة الكردية، على الرغم من طرحها مشروع " الحكم الذاتي"، لكن ذلك لم يمنع من اتخاذها إجراءات تعسفية مشدّدة، وهكذا انقطع حبل الود والثقة في مسيرة الحل السلمي وازدادت اللوحة قتامة باندلاع القتال وما بعده، ولم أجد مبرّراً مقنعاً حينها لانخراط الشيوعيين في القتال مع الحكومة ضد الأكراد، خصوصاً ما أعقب ذلك من أعمال عنف وتهجير وقسوة لم يكن لها مبرر على الإطلاق.
العنف ضعف وليس قوة
كنتُ أنظر إلى العنف باستمرار باعتباره نقطة ضعف وليس مصدر قوة، والقوة غير العنف، بل هي ما أخذت أعبّر عنه بالتدريج بواسطة اللّاعنف، سواء أسميته أو لم أسمّيه، خصوصاً في الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني كقوة اقتراح واحتجاج في آن، للتأثير على أصحاب القرار، لأنها تتمثّل في إرادة بالمواجهة والمقاومة والمجابهة بوسائل لا عنفية، وقد مثّل العنف بالنسبة لي باستمرار ظاهرة غير شرعية أو أن شرعيتها ناقصة أو لم تكتمل بغض النظر عن مسوّغاته.
وكانت تلك الإشكالية محطّ تساؤل مستمر بيني وبين نفسي، لاسيّما بين ما هو أخلاقي وبين ما هو سياسي أو فكري إضافة إلى ما هو قانوني، على الرغم من الشعارات ذات الرنين العالي والمبرّرات الكثيرة، وكنتُ أجد حرجاً أخلاقياً مع نفسي حين يتم تبرير القتل وما سواه من وسائل إرغام.
وحتى حين يتم اللجوء إلى العنف اضطراراً، كما سترد الإشارة إليه، فإن فريضة اللّاعنف ستبقى هي الأساس، ولذلك فإن ضرورات استخدام العنف لا تلغي تلك الفريضة، التي ينبغي أن تظل بوصلتها هادية، ففيها التعبير الحقيقي عن إنسانية الإنسان وميله، بل وسعيه باتجاه أنسنة سلوكه وتحضّره ومدنيته وبالتالي تحقيق إنسانيته.
العنف والآيديولوجيا
حاولت الآيديولوجيات التي عملنا تحت لوائها أن "تعقلن" العنف و"تُشرْعنْ" القضاء على الخصم، باسم "الشرعية"، التي تكتسب عنوان مصالح الطبقة العاملة في الفكر الشيوعي، وذلك بتأكيد استمرار الصراع الطبقي الذي هو في الغالب يتحوّل إلى صراع عنفي لأنه صراع تناحري إلغائي، وفي الفكر القومي - البعثي إلى مصالح الحزب والثورة وتحرير فلسطين، حتى لو تطلب الأمر إلغاء الآخر بالعنف، طالما يكمن الهدف في "المصلحة القومية "، أما بالنسبة للإسلاميين فمصالح "الأمة الإسلامية" في الفكر الإسلامي، هي الأساس.
وحسب الفقه الشيعي فالمعركة والقتال يمكن أن يستمرّا حتى ظهور "المهدي المنتظر"، أي أنه سيكون دائمياً وسرمدياً، وحسب الفقه السني بسط إرادة الإسلام ونشر دعوته في مواجهة الكفر والضلال إلى يوم الدين، وقد بلورت داعش وأخواتها ذلك بالجهاد متعكّزة على حجج ماضوية لا يجمعها جامع مع تعاليم الإسلام السمحاء، وأقصد به روحه ومقاصده ، ناهيك عن لغة العصر.
إن الآيديولوجيات الشمولية جميعها وقعت في نهاية المطاف ضحية نفسها، فـ"العنفية العقلانية" التي حاولت التعكّز عليها كان هدفها إيجاد مبرّرات مشروعة لها لممارسة العنف ونزع سلاح الخصم وإرغامه على الانصياع، لكن تلك العنفية العقلانية ذاتها، استخدمت ذريعة للتصفيات الداخلية بزعم التآمر أو مخالفة المبادئ أو ما سوى ذلك من مبررات وراح ضحيتها أقرب الناس إليها.
وكم من مرّة في التاريخ القريب وليس البعيد "الثوري وغير الثوري" يحصل هذا. ونستحضر هنا ما قام به هتلر في الحادثة المشهورة بـ "ليلة السكاكين الطويلة" أو "عملية الطائر الطنان" وهي عملية التطهير التي وقعت في ألمانيا النازية بين 30 حزيران(يونيو) و 2 تموز(يوليو) 1934، عندما نفذ النظام النازي سلسلة من عمليات الإعدام السياسية. ومجزرة الثلاثينات وما بعدها التي ارتكبها ستالين بحق رفاقه، ثم أصبح العدد بمئات الآلاف، بل بالملايين، وسار على هداه منغستو هيلا ميرام (أثيوبيا) الذي دعا قيادته إلى وليمة للدم فقام بتصفيتهم، وحصل الأمر على نحو مشابه في أحداث اليمن والصراع الدموي الذي راح ضحيته قيادات بارزة من الحزب الاشتراكي وفي مقدمتهم عبد الفتاح اسماعيل، إضافة إلى نحو 13 ألف إنسان، وشهدت بغداد مجزرة قاعة الخلد العام 1979 التي أودت بنحو ثلث القيادة القطرية لحزب البعث وعشرات من الكوادر المتقدمة وغيرها.
وقد برّرت الآيديولوجيات الشمولية، اليسارية والفاشية والقومية والدينية، وخصوصاً في التطبيقات الملموسة والعملية، التضحية بالبشر لأجل الهدف، وكل حسب منطوقه، وبهذا المعنى حتى لو كانت الغايات نبيلة ، فإن التباس الوسائل، لاسيّما اقترانها بالعنف يهدّد الغايات ذاتها، حيث يصبح العنف ماكنة عمياء للدمار والهدم والمحق والموت.
كل ذلك يتم إدراجه حسب الآيديولوجيات الشمولية تحت عنوان "الوعد" بسعادة مؤجلة للبشر والأهداف الكبرى والطموحات العظيمة، وهذا ليس سوى جعل كرامة الإنسان وحقوقه، ورقة للمقايضة بزعم المستقبل، أي مقايضة التنمية وحقوق الإنسان وخياراته الحرّة، بأهداف آيديولوجية شمولية ووعد مستقبلي.
وحسب ألبير كامو إن الدفاع عن الحقيقة بواسطة العنف، هو البدء بإنكارها إذْ يفترض الدفاع عن القيم النبيلة احترامها أولاً وقبل كل شيء لا انتهاكها بزعم توفير فرصة مستقبلية لاحترامها،أي إن وسيلة النضال ينبغي أن تكون عادلة ونبيلة بالانسجام مع الهدف العادل والنبيل، حينذاك سيكون مثل هذا التماهي بين الوسيلة والغاية أساساً في الانتصار الحقيقي، أي انتصار إنسانية الإنسان.
كنت أتجرّع بمرارة أفكار العنف التي تحوم حولي وأجد في نقيضها راحة وطمأنينة ورحابة، وقد يكون بحكم تكويني العائلي وبيئتي الأولى المتسامحة والمسالمة، لست بعيداً عنها، وأقدّر هنا فضل والدي وأعمامي وأخوالي الذين لم يكن أحداً منهم يميل إلى العنف، وإن تربيتهم لأولادهم وبناتهم كانت سلمية، بل إن العنف العائلي، لم يكن معروفاً في بيتنا، مثلما أعرف ذلك في بيوت الأعمام والأخوال جميعهم.
ولذلك حين بدأ وعيي الأول بالتكوّن كنت نافراً من العنف بصورة عفوية من دون فلسفة أو وعي. وحين التحقت بفصائل الأنصار الشيوعية لم يكن في بالي إطلاقاً أن يكون لديّ سلاح شخصي أو أنه يجب عليّ حمله، فذلك لم يكن بالنسبة لي سوى مناسبة لالتقاط صورة تذكارية ليس أكثر من ذلك، لأن مهمتي كانت إعلامية وثقافية، حيث كنت مسؤولاً عن فصيل الإعلام المركزي والمنظمة الحزبية فيه، وكان لنا جريدة وإذاعة، مثلما كنت منشغلاً في قضايا التثقيف وإلقاء المحاضرات والعمل الفكري عموماً، ولاسيّما من خلال لجنة العمل الآيديولوجي، كما كان اسمها.
وحين هوجمنا من جانب قوات الاتحاد الوطني الكردستاني (أوك) بطريقة غادرة ومخادعة، بدعم أو تواطؤ حكومي (أيار/مايو/1983)، كنتُ قد أعطيت ما خصّص لي من سلاح وهو مسدس لم أفتحه ولم أعرف كيف يطلق النار ولا فكّرت حتى من باب الفضول الاطلاع عليه، أعطيته إلى أحد رفاقي، وحين سألني كيف ستدافع عن نفسك حين يقترب المهاجمون منّا، فرفعت له القلم الذي كان في جيبي وقلتُ له بهذا ، قال لي الأمر غير معقول، فقلت له لم أتعلّم مهنة القتل، ولست راغباً في تعلّمها حتى لو يكلفني الأمر حياتي، لأنها مهنة مقرفة وأنا غير مستعد لاستبدال القلم بالبندقية، واختتمت حديثي بـ" البركة بالموجودين الذين سيقومون بذلك" وقد كان من بين صفوفنا شباب شجعان بلا حدود وهو ما سبق لي أن قلتُ أكثر من مرّة "إنني أنحني لهم " مثلما كان هناك بعض المتخاذلين.
ثم مازحته على الرغم من أننا كنّا في وضع مزري جداً وإن وضعي الصحي لم يكن حينذاك على ما يرام، بقولي ونحن ننسحب بعد قرار بإفراغ موقعنا في بشتاشان، إن المسدس ثقيل عليّ حمله، لاسيّما حين توجهنا لعبور جبل قنديل الشهير والذي يبلغ ارتفاعه 7800 قدماً وتكسوه الثلوج شتاء وصيفاً، باستثناء شهري تموز وآب (يوليو واغسطس)، حيث سرنا على الأقدام أكثر من 32 ساعة، حتى وصلنا أول موقع للحزب الديمقراطي الكردستاني، واتضح أنه بالقرب من قضاء "خانة" داخل الأراضي الإيرانية.
وكان نوع السلاح الذي يخصّص للقادة أو الكوادر المتقدمة هو دليل على المكانة التي تشير إلى الاحترام والهيبة التي تفرضها العلاقة بالفلاحين وأبناء القرى التي نمرّ عليها أو يمرّون علينا، وقد بقيت رافضاً حمل السلاح، طيلة فترة وجودي في قوات الأنصار، بما فيها خلال احتدام المعارك التي راح ضحيتها نحو 60 نصيراً شيوعياً، غالبيتهم الساحقة من أصدقائي أو معارفي، لأنني كنت أشعر أنني لم " أخلق" لهذه المهمّة. وقد كانت تلك إحدى نقاط التحوّل في حياتي نحو العمل اللّاعنفي والحقوقي والإيمان بقيم التسامح وفريضة اللّاعنف.
يوم اللّاعنف العالمي
حين قررت الأمم المتحدة في العام 2008 اعتبار 2 تشرين الأول (أكتوبر) من كلّ عام يوماً عالمياً للّاعنف، التَفتَ العالم إلى أن هذا اليوم يصادف عيد ميلاد غاندي، فيلسوف المقاومة السلمية - اللّاعنفية، وكان ذلك الإعلان قد صادف مرور 60 عاماً على اغتياله 1948، و40 عاماً على اغتيال مارتن لوثر كينغ 1968 قائد الحركة المدنية الأمريكية المطالبة بالمساواة. وهكذا أصبح مبدأ اللّاعنف الفلسفي بقرار الأمم المتحدة عالمياً.
والتقط الفكرة شخصيات لاعنفية عربية ريادية كان لها باع طويل في هذا المجال، فبادرت في العام ذاته لتأسيس جامعة اللّاعنف في لبنان والتي أُطلقت في العام الذي تلاه، الأمر الذي وضع فلسفة اللّاعنف ونشر ثقافته موضوعاً راهناً، ليس في جانبها الأكاديمي فحسب، بل في جانبها الاجتماعي والمدني، بحيث دخلت الساحة الفكرية، كإحدى الفلسفات المُعترف بها والتي تمثّل مرجعية ذات خلفية بحاجة إلى المزيد من التعمّق لتأصيلها، وهو ما وجدت نفسي منخرطاً فيه مع أصدقاء وأحبّة وفي مقدمتهم أوغاريت يونان ووليد صليبي وإلهام كلّاب ووفاء الضيقة حمزة وموسى فريجي وعصام منصور وانضّم إلى مجلس أمناء الجامعة " العالمي" عدد من الشخصيات المهمة بينهم من يحمل جائزة نوبل وبمشاركة فاعلة من صديقنا جان ماري مولر وآخرين. وكنت قد هيّأتُ نفسي لمثل هذا التحوّل على مدى يزيدُ على ربع قرن من الزمان من خلال كتاباتي والعديد من الفعاليات والأنشطة التي نظمتها حول التسامح والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
غالباً ما نجد في الثقافة السائدة في مجتمعاتنا مبرّرات وذرائع وحجج لاستخدام العنف، والسؤال الذي يظلّ حائراً : من المسؤول عن العنف، هل الإنسان، بما يمثّله من إرادة ووعي وعقل أم إن للطبيعة البشرية دور في ذلك، إضافة إلى عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية وبيئية ووراثية وغير ذلك؟
وثمة أسئلة من هذا القبيل، هل يبقى العنف أزلياً أم أنه يمكن أن يكون عابراً في التاريخ؟ ونعيد طرح السؤال بصورة أخرى: هل يمكن التغلب على العنف، أم إن الدعوة إلى اللّاعنف هي صيغة مثالية؟ وماذا عن الطبيعة الإنسانية؟ أليس هي عدوانية عنفية أم أنها تلوّثت بذلك؟ وثمة شحنات لا عنفية لدى كل إنسان يمكن تنميتها وتطويرها والانتقال بها لتصبح منهجاً غالباً وقاعدة راسخة، ثم كيف يمكن تحريكها وتحفيزها خصوصاً بضخّها بالثقافة اللّاعنفية والكشف عن الجوانب الكامنة لإظهارها؟ خصوصاً إذا توفّرت شروط موضوعية وأخرى ذاتية.
وإذا كان الإنسان هو من يقوم بالفعل المادي أو المعنوي لممارسة العنف، لأنه وحده القادر على استخدامه، فإنه أيضاً هو من يقدّم مبرّراته لممارسته، سواء كانت مقنعة أم غير مقنعة، وقد يجد تلك المبررات أو الحجج في الآيديولوجيات والعقائد أو في الأديان والمذاهب أو في نمط الثقافة السائد، تلك التي تحاول أن تُشرْعن العنف وتسوّغه، بحيث تجعل من استخدامه "مقبولاً" أو مبرّراً .
إذاً كيف السبيل للحديث عن اللّاعنف وسط ازدحام المشهد العام المحلي والإقليمي والدولي بالعنف، حيث تطغى الثقافة العنفية على ما سواها تحت عناوين ومسوّغات مختلفة، فهل من الممكن التخلّص من العنف كظاهرة سائدة، بالمطلق أم ثمة مساحة يبقى فيها استخدام العنف مبرّراً حتى وإن كانت محدودة، وإنْ كانت اختلافات بيّنة في تحديد تلك الحدود والمساحات؟
القطيعة مع العنف
مثل غيري ممن تصدّوا للظاهرة أعترف أن مفهوم اللّاعنف هو مفهوم جديد على مجتمعاتنا وثقافاتنا، بل على الثقافة البشرية برمّتها، سواء المتقدّم منها أو المتأخر، خصوصاً وأن هناك تقاليداً موروثة من العنف، بل جبالاً وعرة منه على مرّ التاريخ، قد تحجب أية رؤية جديدة لفلسفة اللّاعنف. فكيف السبيل إلى إحداث القطيعة المعرفية العملانية مع العنف سواء على المستوى الشخصي أو الاجتماعي العام؟علماً بأن مفاهيمنا الآيديولوجية تشرّبت بالكثير من العنف، ليس هذا فحسب، بل إن ممارسات باسم الدين وجدت ضالتها في العنف غير المقنن، بل في عنف منفلت، لاسيّما بسيادة فكرة التعصّب، الذي ينجب التطرّف، وهذا الأخير إذا ما تحوّل إلى فعل مادي يؤدي إلى العنف والإرهاب.
والعنف عمل يقصد منه إلحاق الأذى الجسدي والنفسي، المادي والمعنوي بشخص أو مجموعة من الناس بعينهم، أي إن الضحايا سيكونون معروفين للجاني والمرتكب، في حين إن الإرهاب عمل عشوائي يستهدف إحداث أذى ورعب وهلع وخوف في المجتمع للتأثير على الرأي العام، وغالباً ما يكون هدفه سياسياً ويكون الضحية أو الضحايا غير معروفين للجاني أو المرتكب.
وإذا كان العمل العنفي يندرج في إطار القوانين الجنائية، وإن الجزاء والعقاب يخضع للقوانين والأنظمة القضائية المحلية، فإن الإرهاب يندرج في إطار القوانين الدولية، سواءً كانت داخلية أم خارجية، لأنه يمثّل جريمة دولية تستهدف الإبادة الجماعية وهي جرائم ضد الإنسانية، إذا ما استهدفت ديناً أو طائفة أو فئة أو إثنية أو لغة أو سلالة، تحت مبرّرات إقصائية وإلغائية تمييزية.
إن من يفكّر بالقطيعة مع العنف، قد يُتّهم أحياناً بأنه يفعل ذلك لكي يمارس قطيعة مع الدين ذاته، لأن في الأديان نظام عقوبات صارم كما يقولون، خصوصاً وأن الغالب الشائع من التفسيرات تؤدي إلى مثل هذا الاستنتاج الذي هو في حقيقته، مجرد تأويل وقراءة إرادوية سطحية للأديان وقيمها، وحسب هذا التفسير أو التبرير، فالعبرة هي ليس بالنادر الضائع، لاسيّما إذا كانت المصالح والأهواء هي المهيمنة من جانب قوى سائدة تتمترس في مواقعها وتدافع عنها بأسنانها، بل إنها هي التي تهاجم، وبالعنف، من يريد نيل حقوقه أو وقف استغلاله لتحقيق قدر من العدالة والمساواة. إذاً فكيف السبيل لإشاعة ثقافة اللّاعنف، بحيث تصبح مثل هذه الفلسفة سائدة ليس ببعدها الأخلاقي فحسب، بل في جانبها الحقوقي وبُعدها القانوني؟
غاندي والحقيقة
إذا كان اللّاعنف حسب غاندي يعبّر عن حقيقة الأديان، لأنه ليس آيديولوجيا أو عقيدة أو تعاليم دينية، بل هو فلسفة، والفلسفة في أحد تعبيراتها هي "حبّ الحكمة" ، وحتى غاندي لم يقل إن الإنسان يمتلك الحقيقة المطلقة، لأن من يقول ذلك سيكون مستعداً لإلغاء الآخر أو إقصائه أو تهميشه، بزعم امتلاكه للحقيقة، تلك التي تدعوه للدفاع عنها، حتى وإن استخدم العنف ضد خصومها، الذين هم خصومه. وهكذا سيكون العنف وسيلة للدفاع عن حقيقته الخاصة، تلك التي تنتقص من الآخر وتضعه في مصاف العدو أو الخصم الذي ينبغي إخضاعه.
هكذا دافعت الآيديولوجيات عن نفسها عبر قادة أو أحزاب أو جماعات، لأنه دفاع عن فلسفتهم ودينهم وعقيدتهم، ولكن السؤال هل الحقيقة آيديولوجية، أي عقائدية ، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو دينية أو مذهبية أو غير ذلك؟ وإذا كان الجواب نعم حسب دعاة العنف، فإن من يدّعي امتلاك الحقيقة ينفي الآخر، يعزله ، بل ويجهز عليه إذا شعر إن ثمة حقيقة أخرى قد لا تكون آيديولوجية تواجه حقيقته، وهي حقيقة إنسانية ، تتعلّق بالوجود الإنساني، وهي الحقيقة الأهم والأساس، التي يحاول العنفيون إلغاءها أو تعطيلها بفرض آيديولوجيتهم. وهكذا تضيع الحقيقة الوجودية التي لا تعني سوى الاعتراف بالآخر والإقرار بالتنوّع والتعددية، وهذا بحدّ ذاته تفاعل وتداخل مع فلسفة اللّاعنف، بنقض فلسفة العنف.
إن الزعم بامتلاك الحقيقة يمثّل الخلفية الفكرية للتعصّب، وهذا إذا ما سيطر على الإنسان، فسيدفعه إلى التطرّف، لأن كل متطرّف إنما هو متعصّب، وإذا ما حاول المتطرّف فرض إرادته على الآخر، ففي الغالب الأعم يلتجئ إلى العنف لإرغام الآخر، ويبرّر ذلك بامتلاكه للحقيقة والأفضلية، تلك التي تعطيه " شرعية" للقيام بفرض عقيدته أو آيديولوجيته أو دينه أو مذهبه أو نمط حياته على الآخر.
العنف وجه آخر للباطل
لعلّ ذلك يعبّر عن جوهر العنف الذي سيكون وجها آخر للباطل، لأن هذا الأخير ينبثق من زعم إدعاء الأفضليات وتمثيل الحقيقة، وهكذا سيكون كل تبرير للعنف بهذا القدر باطلاً، لأنه يريد أن يفرض الرأي بإقصاء الآخر وبالعنف إذا اقتضى الأمر، وهذا ما يجد تبريره عند بشر يزعمون أن الحقيقة معهم حيثما مالوا تميل.
ولكن هل الدعوة إلى اللّاعنف مطلقة؟ يجيب غاندي على ذلك بالنفي ويشرح ذلك بتفسير منطقي وواقعي، فإذا تعذّر أن نحيا بلا عنف بصورة مطلقة، فلا بدّ إذاً من استخدام مقنّن ومحدود للعنف، لأننا في الحياة يستحيل أن نتجنّب كل عنف، كما إن كل شيء نسبي، ولكن الاختلاف حول حدود العنف يتراوح من حالة إلى أخرى، وهذه الحدود ليست متساوية لدى جميع البشر وكل منهم لديه رؤاه وممارساته التطبيقية، حيث أحياناً يتم اللجوء إلى العنف لتجنّب الأسوأ أو لدرء وقوع كارثة أخطر وأشدّ هولاً، وهو ما يُطلق عليه "قانون الضرورة الأسود".
القاعدة والاستثناء
ونقول بالعربية "الضرورات تبيح المحظورات"، أو"للضرورة أحكام"، وهو قول بليغ على تجاوز القاعدة باتجاه الاستثناء، وهذا ليس سوى تقنين لاستخدام العنف بحدّ الأدنى باسم " حُكم الضرورة" . وإذا كان ثمة واقعية في الأمر، فإن هذا الاستخدام ينبغي أن يخضع لضوابط وحدود وزمن، خصوصاً وإن هناك حالات تستوجب مثل هذا العنف، كأن يكون "حالة الدفاع عن النفس" لرد الاعتداء مثلاً سواء كان الاعتداء شخصياً أو عاماً، مثل مواجهة احتلال أو مجابهة غزو أو لتحييد عدوانية المعتدي. وحتى في هذه اللحظة علينا أن نتذكّر دائماً، بل نبقي نصب أعيننا إن اللّاعنف هو القاعدة، والعنف هو الاستثناء، أي أننا إذا اضطررنا اللجوء إلى العنف فإنه ليس خياراً، بل أقرب إلى الإكراه، والإرغام، حين تتقدّم الوسائل الأخرى.
وإذا كان مثل هذا الاستخدام للعنف المقنّن ضرورة مرهونة بظرفها التاريخي، فإنها لن تكون مساوية للشرعية، لأنها استثنائية وانتقالية وظرفية، في حين إن الشرعية هي القاعدة، وهذه هي تمثل اللّاعنف. والشرعية تتأتّى دائماً من القاعدة وليس من الاستثناء، فالضرورة تقنّن حرّية خياراتك أحياناً، أي أنك لست حرّاً في اختيار وسيلتك، ولو كان الأمر كذلك، أي لو توفّرت أوضاع وظروف أخرى لاخترت غير تلك الوسيلة، وهكذا سيكون تبرير العنف بالضرورة ليس مساوياً للشرعية، لأنه هذه الضرورة ليست حتمية، وقد تتاح للمرء فرصاً عديدة لتجاوز "ضرورة " استخدام العنف، إلى عكسها.
الغاية والوسيلة
الأمر له علاقة وثيقة وعضوية بين الغاية بالوسيلة، فالغاية العادلة، حسبما تزعم الآيديولوجيات والعقائد الشمولية والنسقية المغلقة تبرر استخدام جميع الوسائل بما فيها العنف الذي سيكون مشروعاً، لأنها أهدافها عادلة كما تزعم، وهكذا يمكن تعذيب إنسان أو امتهان كرامته أو تعريضه للأذى الجسدي أو النفسي، طالما تزعم الجهة التي تقوم بذلك أن هدفها عادل وبالتالي سيكون مشروعاً ما تقوم به. وإذا كان ذلك على المستوى الشخصي أو السياسي المحدود، ففي العلاقات الدولية هناك امتدادات له ومزاعم مختلفة ومتنوعة.
وتبرّر اليوم القوى المتسيّدة في العلاقات الدولية، استخداماتها للقوة أو التهديد بها أو القيام بأعمال عنف لبسط إرادتها، سواء كان عنفاً مسلحاً باستخدام السلاح والحروب، أم عنفاً اقتصادياً بفرض نظام عقوبات أو عنفاً ثقافياً بمحاولة ضخ وتعميم نمط سائد للثقافة، وازدراء الآخر، ويتم ذلك تحت عناوين " مكافحة الإرهاب" و"الحرب المشروعة" و"العادلة" و"الوقائية" و"الاستباقية".وأحياناً وبموجب علاقات القوة والتسيّد يتحوّل الضحايا إلى إرهابيين مثل ما تتهم "إسرائيل" المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، في حين أن الفلسطينيين يمارسون حقهم في الدفاع عن أنفسهم وتقرير مصيرهم ضد محتلّي بلادهم ومن أجل حريتهم واستقلالهم.
وإذا كان كلٌّ يلقي اللوم على الآخر أيضاً، فمن يا ترى يملك الحقيقة وهو ما دفع الأديب الروسي الكبير تولستوي للقول " إذا كان الجميع يدافع عن نفسه فمن أين يأتي الهجوم"؟، أي من هو البادئ ومن هو المسبّب، ولعلّ هذه الفكرة الواقعية نراها تتكرّر في الحروب الدولية والنزاعات المسلحة والأهلية وحتى بين الجماعات الدينية والكتل السياسية والأشخاص أحياناً، لأن كل فريق يحاول أن يضع الحق إلى جانبه وبالتالي يعطي نفسه شرعية استخدام العنف أو ممارسته بحيث يتم إجبار الآخر على الاستسلام أو الهرب.
وتبرّر الآيديولوجيات العنف بربطه بالعدل أي الزعم بتحقيق العدل بواسطة العنف، وحتى يكون الأمر ذلك منطقياً، فإن القضية التي تستوجب القيام بالعمل العنفي لا بدّ أن تكون "مبرّرة"، لأنها عادلة حسب وجهة النظر هذه، ولأجلها تهون كل القضايا، بما فيها استخدام العنف. أما العدو أو الخصم فلا شكّ فإن قضيته ظالمة أو غير عادلة ، وتلك أسباب ومبرّرات تشمل الخلافات الشخصية والنزاعات الأهلية والمسلّحة والحروب، وهي تتعلّق بالمصالح ومناطق النفوذ والامتيازات ومحاولات الهيمنة وفرض الاستتباع وإملاء الإرادة.
تصوروا مثلاً تبرير داعش " تنظيم الدولة الإسلامية للعراق والشام" التي تعتبر الجميع خصومها، لأنها هي وحدها الفرقة " الناجية" وكل ما حولها إنما هو من قبيل البدع، "وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار"، وكان خطاب أبو بكر البغدادي في جامع النوري الكبير بالموصل بعد احتلالها بنحو عشرين يوماً أي في 29 حزيران (يونيو) 2014 ، قد اعتبر نفسه مدافعاً عن الإسلام بل خليفة للمسلمين محاولاً إضفاء الشرعية على تصرفاته وسلوكه.
وليس داعش أو تنظيم القاعدة أو أخواتهما هو من يسلك هذا السبيل لوحده، فدولة عظمى مثل الولايات المتحدة برّرت حربها على العراق واحتلاله بفريّة كبرى وهي وجود أسلحة دمار شامل ، إضافة إلى علاقته بالإرهاب الدولي، ومارست ضده حصار دولي جائر لمدة زادت على 12 عاماً، وذلك من أجل تسويغ فعل الحرب والعنف ضده، لأن الهدف "عادل" حسب مبرّراتها، وكانت تعتبر حربها على الفيتنام والتي راح ضحيتها مئات الآلاف من الضحايا، بما فيهم عشرات الالاف من الجنود الأمريكان، "عادلة"، لأنها تدافع عن "المدنيّة" و"التحضّر"، بل إن حصارها على كوبا الذي زاد على خمسة عقود من الزمان، إنما هو دفاع عن "العالم الحر" وقيمه، وهكذا كانت وسائل الدعاية والصراع الآيديولوجي ضد الاشتراكية لعقود من الزمان.
لقد برّرت واشنطن استخدامها للعنف بهدف مواجهة ظاهرة الإرهاب الدولي، وحاولت إيجاد مسوّغات "قانونية" و"شرعية" لشنّ حربها على أفغانستان العام 2001 والعراق العام 2003، وذلك بعد مهاجمة تنظيم القاعدة برجي التجارة العالمية في نيويورك العام 2001، وتمكّنت من استصدار قرارات دولية تعطيها المبررات لممارسة العنف وهو ما حاولت أن تمرّره من خلال الأمم المتحدة بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر الإرهابية الإجرامية، حيث صدرت ثلاثة قرارات هي الأخطر في تاريخ المنظمة الدولية، وأهمها القرار 1373 الصادر في 28 أيلول/سبتمبر 2001، الذي فيه عودة لقواعد القانون الدولي التقليدي التي تجيز " الحق في الحرب" و"الحق في الغزو" أنّا شاءت الدولة، وإذا شعرت بأي تهديد لمصالحها القومية ومجالها الحيوي.
وقد أعطى هذا القرار للدول الحق في شن الحرب بزعم وجود خطر وشيك أو محتمل، وهي "حرب وقائية" أو "استباقية" ولكن ضد عدو مجهول أو غير معروف إلّا باسم "الإرهاب الدولي"، وهو الذي تحدّده الولايات المتحدة والقوى المتنفذة، ولم يكن ذلك سوى تسهيل مهمتها و"شرعنة" العنف طبقاً لأهدافها "القومية" ومصالحها " المشروعة".
لقد برّر ستالين ملاحقة ضحاياه وقتل الملايين من البشر بـ "الدفاع عن الاشتراكية" ضد الأعداء والامبرياليين والمتواطئين معهم، وشنّ صدام حسين حروبه باسم الحقوق وبهدف منع التآمر على نظامه، ناهيك عن تصفية خصومه، سواء داخل حزبه أو خارجه... كل ذلك تحت مزاعم امتلاك الحقيقة، والغايات الشريفة التي تبرّر استخدام جميع الوسائل حتى وإن كانت غير عادلة، وباختصار إن ذلك يعني "الغاية تبرر الوسيلة" وهو المبدأ الميكافيللي الذي لا يقيم وزناً للإنسان.
وكان كتاب "الأمير" للفيلسوف الإيطالي ميكافيللي قد صدر إبان عصر النهضة، وهو من الكتب التاريخية المهمة في علم السياسة، رغم مضي أكثر من 5 قرون على صدوره، وعلى افتراض وجود غايات عادلة ، فهل يمكن استخدام وسائل غير عادلة لتحقيقها؟ هل يجوز ذلك أخلاقياً وفكرياً وقانونياً أم ثمة اختلالات بنيوية، لاسيّما بين العنف والأخلاق؟ فالعنف يجعل القضية العادلة قضية غير عادلة ووسائل العنف تحطّ من شأن القضايا العادلة. ولكي نصل إلى الغاية العادلة يجب استخدام وسائل عادلة أيضاً، أي الانسجام والتناغم بين الغاية والوسيلة التي يتم السعي لتحقيقها.
وكنتُ دائماً ما أضرب مثلاً بخصوص الحصار المفروض على العراق بالقول: إن الزعم بمحاصرة العراق هو نظامه، إنما هو سخرية لمن يقوم بها ولمن سوّغها أو لمن يحاول التواطؤ معها أو الاقتناع بها، وهو أقرب إلى استهداف طائرة ركاب تقلّ على متنها 380 راكباً، بحجة وجود إرهابي واحد عليها أو الشك بوجوده، أو مثلما هو تجفيف بحيرة كاملة وحرمان السكان من الماء بحجة وجود سمكة خبيثة فيها، ومثل هذا العنف الجماعي هو لا إنساني وهو ينطلق من تبرير الأسلوب الميكافيلي: الغاية تبرر الوسيلة، في حين إن الوسيلة جزء من الغاية، وإذا كانت الغاية غير معروفة بالملموس ، فالوسيلة ملموسة، وبالتالي لا يمكن أن تكون وسيلة غير عادلة تنافح وتكافح من أجل قضية عادلة.
والعلاقة بين الوسيلة والغاية حسب غاندي، الذي كثيراً ما استشهدت به، هي علاقة عضوية متينة ومترابطة ولا انفصام بينهما، لأن الغاية كامنة في الوسيلة، وهي مثل "علاقة البذرة بالشجرة"، والعكس صحيح. وإذا كنّا لا نستطيع التحكّم بالغايات، لاسيّما وهي بعيدة المدى لأنها تتعلّق بالمستقبل، فإننا يمكن أن نسيطر على الوسائل، لأنها جزء من الحاضر، أي إن الغاية تعيش للمستقبل، أما الوسيلة فهي تعيش في الحاضر.
وقد حاول كارل ماركس ورفيقه انجلز تبرير استخدام العنف باستمرار صراع الطبقات، وحين يزول هذا أو يحلّ لصالح انتصار الاشتراكية والشيوعية، فسيزول معه كل عنف، لاسيّما بزوال الظلم وسيادة العدل، أي تبرير استخدام العنف بانتظار المستقبل، ويظل ذلك مجرد وعد، لكن الحقيقة سارت باتجاه آخر، ويختلف اللّاعنفيون عن مبرّري العنف، إنهم لا يعدون أحداً بالمستقبل، إنما وعدهم هو "الآن... الآن... وليس غداً" ، أي إن استعمال الوسيلة هو المقدمة الضرورية للغاية.
العنف يفرض نوعاً من التشابه، بل يجبر على مثل هذا التشابه أحياناً، وذلك بجعل مجموعات سكانية ثقافية دينية أو لغوية أو إثنية أو سلالية تتشابه فيما بينها، وذلك تحت زعم امتلاك الحقيقة وادعاء الأفضليات، إضافة إلى عوامل أخرى، في حين أن أفرادها مختلفون . العنف وحده هو الذي يجبرهم على مثل هذا "التشابه" الإجباري الإكراهي، في حين إن اللّاعنف هو خيار الاختلاف، وهكذا هم البشر مختلفون ومتباينون بحكم تلقائيتهم وعفويتهم وظروف نشأتهم وتكوّنهم، إضافة إلى أوضاع حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يناقش صديقي الفرنسي فيلسوف اللّاعنف جان ماري مولر فكرة البير كامو الملتبسة عن فلسفة العنف واللّاعنف، تلك التي تردُ مراراً في رواياته ، لاسيّما في حوادث القتل، فيقول إن بعض خصومه أخذوا عليه هروبه إلى مثالية " اللّاعنف"، على الرغم من أنه لم يدّعه قط، ويعرّج على مقدمة كتبها جان بول سارتر على كتاب فرانتز فانون " معذبو الأرض" العام 1961 بخصوص عنف الشعوب المستعمرة، فيقدّم نقداً لاذعاً للّاعنفيين بقوله ما أشدّ سذاجتهم فهم "لا ضحايا ولا جلادون" في تلميح واضح إلى ما كتبه كامو.
ويقدّم جان ماري مولر في كتابه " نزع سلاح الآلهة" عرضاً موسعاً للأديان، ولاسيّما للمسيحية والإسلام من منظور فريضة اللّاعنف، مقدّماً قراءة معمّقة للنص الديني مستنتجاً " إن الله لا يسمح بانتصار الشر" وإن حصل ذلك فإمّا إنه ليس قديراً، وإمّا إنه ليس طيباً، والله هو الذي يصلّي للبشر لأنه محبّة، وهو مطلق.
والفريضة التي يتحدّث عنها يقصد بها الفضيلة التي تمنح الإنسان هذا القدر من المحبّة والطهرانية والروحانية الإنسانية، وتقرّب البشر من بعضهم، بغض النظر عن الدين أو حتى الإيمان أو التديّن أو اللّاتديّن ، لأن الجميع يمكن أن يجتمعوا في خيمة التعايش والسلام وحب الخير.
هل اللّاعنف مطلق؟
وإذا احتسبنا كامو على اللّاعنفيين، فإنه مثل غيره لا يؤمن بفكرة " اللّاعنف المطلق"، وإنْ كان يطلّ على بعض أطروحات غاندي بإبداء التقدير له، وهو الآخر كان قد طعن في صحة عدم وجود لاعنف بصورة مطلقة، دون أن يُشرْعِنْ القتل أو ممارسات العنف.
وإذا كان العنف ظاهرة لصيقة بالصراع، وهو في الغالب أحد مخرجاتها أو أبعادها فإنه نوعان: الأول - العنف المباشر، مثل القتل، والتعذيب، والإيذاء الجسدي، والحصار والعقوبات الاقتصادية وغيرها والثاني - " العنف غير المباشر"، وقد يكون هذا ناعماً مثل التمييز في النوع الاجتماعي (الجندر)، في التعليم، لأسباب تتعلّق بالدين والطائفة أو العرق أو القومية أو اللغة أو اللون أو الأصل الاجتماعي.
والعنف يكون أيضاً بواسطة الاستغلال، لاسيّما باستمرار التفاوت الطبقي بين المتخومين والمحرومين، والأغنياء والفقراء في النظام الاجتماعي أو من خلال استقطابات اجتماعية أو دينية ?

 عبدالحسين شعبان
عبدالحسين شعبان