هوامش علي متن الإصلاح الديمقراطي
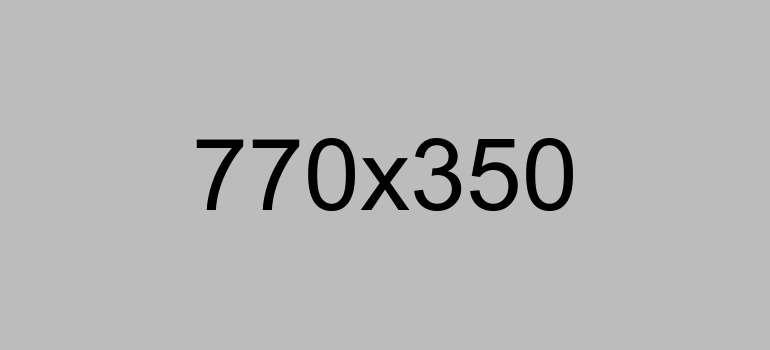
-جريدة الأهرام
اعترف منذ البداية بأن مقالي الماضي قواعد المنهج في التحول الديمقراطي كان شديد الثقافة الفكرية بحيث قد يصعب علي بعض القراء متابعة ما ورد فيه من أطروحات وتساؤلات متعددة.
لذلك وجدت من الضروري أن اعتبره متنا رئيسياText وأقوم في سلسلة من المقاولات بالتهميش عليه, من خلال منظور علم السياسة المقارن, وتجارب عديد من البلاد التي تحولت من الشمولية والسلطوية إلي الديمقراطية, بالإضافة بالطبع للخبرة التاريخية المصرية المتميزة. وذلك لأننا في حوالي ستين عاما خبرنا ثلاثة نظم سياسية مختلفة. النظام الملكي الدستوري الذي ساد منذ صدور دستور1923 حتي يوليو1952, والنظام الجمهوري ذو التوجه الاشتراكي والذي بدأ مع ثورة يوليو1952 واستمر حتي عام1970 وهو تاريخ رحيل الرئيس عبد الناصر, وإن كان النظام كان قد انتهي تاريخيا بحدوث هزيمة يونيو1967, والنظام الجمهوري ذو التوجه الرأسمالي والذي بدأ منذ تولي الرئيس السادات السلطة حتي وفاته, والذي استمر في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك حتي تنحيه بعد ثورة يناير.
وبالرغم من اختلاف هذه النظم السياسية في توجهاتها الإيديولوجية, إلا أنه يمكن القول أن ثورة يوليو1952 هي التي أسست للنظام السلطوي المصري, والذي بنته علي أنقاض النظام الليبرالي قبل1952, وذلك بعد أن ألغته دستور1923 وألغت الأحزاب السياسية, وابتدعت نظام الحزب الواحد, بدءا من هيئة التحرير إلي الاتحاد القومي إلي الاتحاد العربي الاشتراكي, الذي ألغاه السادات وشكل بدلا منه حزبا وحيدا هو حزب مصر العربي الاشتراكي والذي سرعان ماتحول عنه وتركه في العراء وكوب الحزب الوطني الديمقراطي, وأحاطه بديكور من أحزاب المعارضة حتي يضفي علي النظام طابع
التعددية الحزبية, وهو الحزب الذي ورثه عنه الرئيس السابق محمد حسني مبارك وحوله عبر السنين إلي قلعة من قلاع السلطوية المنيعة, والتي ألقت اليأس في نفوس الشعب فيما يتعلق بإمكانية اقتلاعها إلي أن فجرتها ثورة25 يناير علي غير توقع, تفجيرا مدويا!
وقد سبق لنا في مقالنا الماضي أن طرحنا عددا من الأسئلة المهمة تتعلق بمرحلة الانتقال من السلطوية إلي الديمقراطية وهي المرحلة التي تمر مصر بها حاليا والتي تتصارع فيها الآراء بشدة حول مراحل الانتقال واتجاهاتها, وهو صراع لم ينته نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية والتي حسمت بأغلبية واضحة لمن قالوا نعم في مواجهة من قالوا لا, وبغض النظر عن طبيعة تكوين الجماعات السياسية التي شكلت لكل فريق.
ومن بين الأسئلة التي طرحناها وإن كنا لم نجب عليها هو السؤال الجوهري ما الذي ينبغي تغييره وما الذي ينبغي الإبقاء عليه؟
ومما لا شك فيه أن الدستور المطبق لحظة حدوث أي ثورة هو الذي يوضح أولا موضع التساؤل, بمعني نبقي عليه أو نسقطه, باعتباره كان أداة في يد النظام السلطوي استخدمه ـ سواء علي مستوي النصوص أو علي مستوي الممارسة ـ للقمع السياسي ومصادرة حريات المجتمع بالمعني الواسع لهذه الكلمة, وسواء في ذلك حرية التفكير أو حرية التعبير أو حرية التنظيم, أو وهذا هو الأهم حق المجتمع السياسي في تداول السلطة, تجديدا للدماء السياسية واستنهاضا لاتجاهات الحيوية والتقدم المطرد.
وهناك اتجاهات متنوعة اتبعتها الثورات المختلفة فيما يتعلق بالإبقاء علي الدستور أو إلغاؤه وسن دستور جديد.
ولو استحضرنا الذاكرة التاريخية المصرية بهذا الصدد لعرفنا أن أول خطوة حاسمة اتخذها الضباط الأحرار الذين قاموا بالانقلاب علي النظام الملكي في يونيو1952 كان هو إسقاط دستور1923, مع أن هذا الدستور في نظر عديد من الفقهاء الدستوريين كان دستورا نموذجيا لأنه وازن بدقة بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية, وإن كان الملك ـ في مجال الممارسة ـ أساء استخدام سلطاته الدستورية وأقصي حزب الوفد عن الحكم فترات طويلة عن طريق إقالة وزاراته وأتاح لأحزاب المعارضة السياسية والتي كانت تمثل الأقلية أن تحكم بدلا منه, واستخدم في ذلك آلية إقالة الوزارة التي يعطيها له الدستور, مما تسبب في النهاية في عدم الاستقرار السياسي وفي إفقاد النظام طابعه الديمقراطية الأصيل.
وأذكر أنه في الفترة التي تلت قيام الثورة وكنت في العام الجامعي1952 ـ1953 طالبا بالسنة الأولي في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية أن جدلا عنيفا دار بين أنصار إسقاط الدستور كما كانت تريد الثورة وأنصار الإبقاء عليه لأنه هو الضامن للحريات الديموقراطية.
وكانت المفارقة أن أستاذنا العظيم الدكتور سعد عصفور أستاذ القانون الدستوري كان من أشد الإبقاء علي دستور1923 وقاد في الكلية ندوات متعددة بل واحتجاجات لمنع إلغاء الدستور, في الوقت الذي كنا جيل الشباب في هذا الوقت من أنصار إسقاط الدستور لأنه في نظرنا لم يكن يعبر عن الروح الثورية!
ما أشبه الليلة بالبارحة! لقد تكرر نفس الجدل بعد ثورة25 يناير التي أسقطت النظام السياسي السلطوي بضربة واحدة, وذلك بصدد الإجابة علي السؤال نبقي الدستور أو نلغيه؟
وقد اتجه المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي تعطيل العمل بالدستور علي أن تشكل لجنة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية وخصوصا في المادتين76 الخاصة بالشروط التعجيزية التي فرضت علي المرشحين المستقلين لمنصب رئيس الجمهورية, والمادة77 الخاصة بإطلاق مدة رئاسة الجمهورية إلي ما لا نهاية!
تمت التعديلات وأجري الاستفتاء ـ كما ذكرنا ـ وكانت النتيجة بنعم بنسبة77.2% تقريبا غير أن الجدل المحتدم لم ينته!
مازال الرأي الرافض للدستور حتي بعد تعديله قائما, لأن أصحابه يرون أنه لابد من صياغة دستور جديد يعبر عن أهداف ثورة25 يناير ويرضي طموحات الشعب في ديموقراطية بلا ضفاف, وليبرالية بلا حدود أو قيود.
وهناك خلافات أخري مهمة بين من يرون ضرورة البدء بالانتخابات البرلمانية ثم تعقبها
الانتخابات الرئاسية حتي يتسني لرئيس الجمهورية الجديد أن يقسم اليمين أمام مجلس الشعب الجديد, ومن يرون علي العكس ضرورة البدء بالانتخابات الرئاسية.
مازال الجدل قائما, وإن كان الاتجاه يسير إلي إصدار إعلان دستوري بنص علي القواعد الأساسية التي ستحكم المرحلة الانتقالية والتي في ظلها ستتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
إذن كان موضوع الدستور ومسألة إبقاؤه أو إلغاؤه وسن دستور جديد عن طريق جمعية تأسيسية كما تقضي بذلك الأعراف الدستورية هو مناط التساؤل الأول.
ويأتي علي الفور السؤال الثاني ما الذي نبقيه من النظام القديم وما الذي نلغيه؟
هنا أيضا تفاوتت الآراء بين هؤلاء الذين يريدون إسقاط كافة الأشخاص الذين كانوا في صدارة الوظائف الرئيسة للنظام القديم وهؤلاء الذين يريدون تطبيق منهج انتقائي لا يتيح الفرصة لحدوث انهيار في الممارسة.
الاتجاة الأول عبر نفسه أولا, في مجال الإعلام حيث ذهب أنصاره إلي ضرورة إسقاط جميع رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير للصحف القومية التي دافعت عن النظام القديم حتي آخر لحظة, بل ومن بينها من هاجم ثورة25 يناير في أيامها الأولي وقدم عنها الإعلام الحكومي صورة مشوهة, وأيضا العمل علي إسقاط الكوادر الإعلامية في مجال الإذاعة والتليفزيون لنفس السبب.
وأكد أنصار منهج الإسقاط الكامل في مجال الجامعات ــ علي سبيل المثال ــ إلي ـ ضرورة إقالة كل رؤساء الجامعات وكل عمداء الكليات وهو اتجاه شباب الثورة من طلبة الجامعات علي أساس أنهم كلهم تقلدوا مناصبهم بالتعيين وليس بالانتخاب وتدخلت مباحث أمن الدولة في اختيارهم.
ومازال هذا الجدل قائما لأن قانون تنظيم الجامعات مازال قائما ولا يمكن إقالة هؤلاء الرؤساء والعمداء بغير تعديل القانون للنص علي قواعد الانتخاب المرجوة.
غير أن الذي ينبغي إلغاؤه في الواقع ليس مجرد إقصاء رموز النظام القديم سواء في ذلك الرموز السياسية أو الإدارية هو إلغاء الممارسات السلطوية التي صادرت حق الشعب في المشاركة.
أهم ما ينبغي إسقاطه هو الانفراد بإصدار القرارات التنموية التي تمس مصالح الملايين من جموع الشعب المصري سواء في ذلك ما يتعلق بالتعليم أو الإسكان أو الصحة أو التأمينات أو حتي في مجال توجهات الاستثمار والتي تؤثر سلبا وإيجابا علي سوق العمل وإمكانية تشغيل جموع الشباب التي تعاني من البطالة.
لقد اعتمد النظام القديم علي ديكتاتورية الأغلبية في مجلس الشعب لتحرير تشريعات تخدم في المقام الاول مصالح القلة من رجال الأعمال علي حساب الغالبية العظمي من الشعب, بل إن مجلس الشعب فشل تحت ضغوط ممثلي الرأسمالية المتوحشة في منع الاحتكار وترك السوق نهبا لأطماعهم التي ليس لها حدود, والتي أدت إلي تراكم ثرواتهم بالمليارات وإفقار الشعب المصري بمختلف طبقاته.
إذن فليكن تركيزنا أولا, وفي المقام الاول وقبل الانشغال الشديد بإسقاط الرموز القديمة علي إسقاط السياسات الفاسدة في الممارسة السياسية برفع كل القيود عن الأداء الديموقراطي الحقيقي, وضرورة مراجعة السياسية الاقتصادية الراهنة التي صيغت لخدمة رجال الأعمال في المقام الأول, ومحاولة تصحيح الخلل الجسيم في البناء الاجتماعي المستقطب بين المنتجعات الفاخرة للقلة والعشوائيات للملايين, وإعادة صياغة السياسة الثقافية حتي لا يقع المجتمع فريسة للجماعات الدينية المتطرفة فكريا والتي تريد العودة بنا إلي مناخ القرون الوسطي بما كان يسوده من تخلف فكري ورجعية سياسية!















